المنفى
آنكا مولشتاين
في الثالث والعشرين من فبراير سنة 1942، انتحر "شتيفان
تسفايج" وزوجته الشابة معا في بيتروبوليس بالبرازيل. وفي اليوم التالي أقامت
الحكومة البرازيلية جنازة رسمية حضرها الرئيس "جيتوليو فارجاس"، وذاع
الخبر بسرعة في أرجاء العالم، ونشر خبر وفاة الزوجين في الصفحة الأولى من نيويورك
تايمز. كان تسفايج أحد أشهر كتاب عصره، وأعماله كانت مترجمة إلى قرابة خمسين لغة.
و"كان ينتمي" حسب ما يرى صديقه الروائي "إرمجارد كوين" إلى
"أولئك الذين يعانون لكنهم لا يستطيعون إلى الكراهية سبيلا. فهو من أولئك
اليهود النبلاء، رقاق الجلود، شديدي الحساسية للإساءة، يعيش في عالم زجاجي نقي
روحاني، تعوزه القدرة على الإيذاء"[i].
أثار الانتحار عاصفة من المشاعر وتشكيلة متباينة من ردود
الأفعال. فلم يكتم "توماس مان" ـ زعيم كتاب الألمانية في المنفى بلا
جدال ـ سخطه على ما ينطوي عليه فعل الانتحار من جبن. وفي برقية بعثها إلى صحيفة
"بي إم" اليومية في نيويورك، أثنى ثناء أكيدا على موهبة زميله الكاتب،
لكنه أكد على "خروجه المؤلم عن صفوف المهجر الأدبي الأوربي بهذا الضعف الشديد
المؤسف". وزاد رأيه وضوحا برسالة بعثها إلى صديق كاتب قال فيها "إنه ما
كان ينبغي له أن يهدي النازيين هذا النصر، وإنه لو كان يُكِنُّ لهم ما يستحقون من
كراهية واحتقار، لما كان أقدم على ما أقدم عليه". فلماذا عجز تسفايج عن إعادة
بناء حياته؟ لم يكن سبب ذلك هو قلة حيلته، مثلما أوضح مان لابنته إريكا.
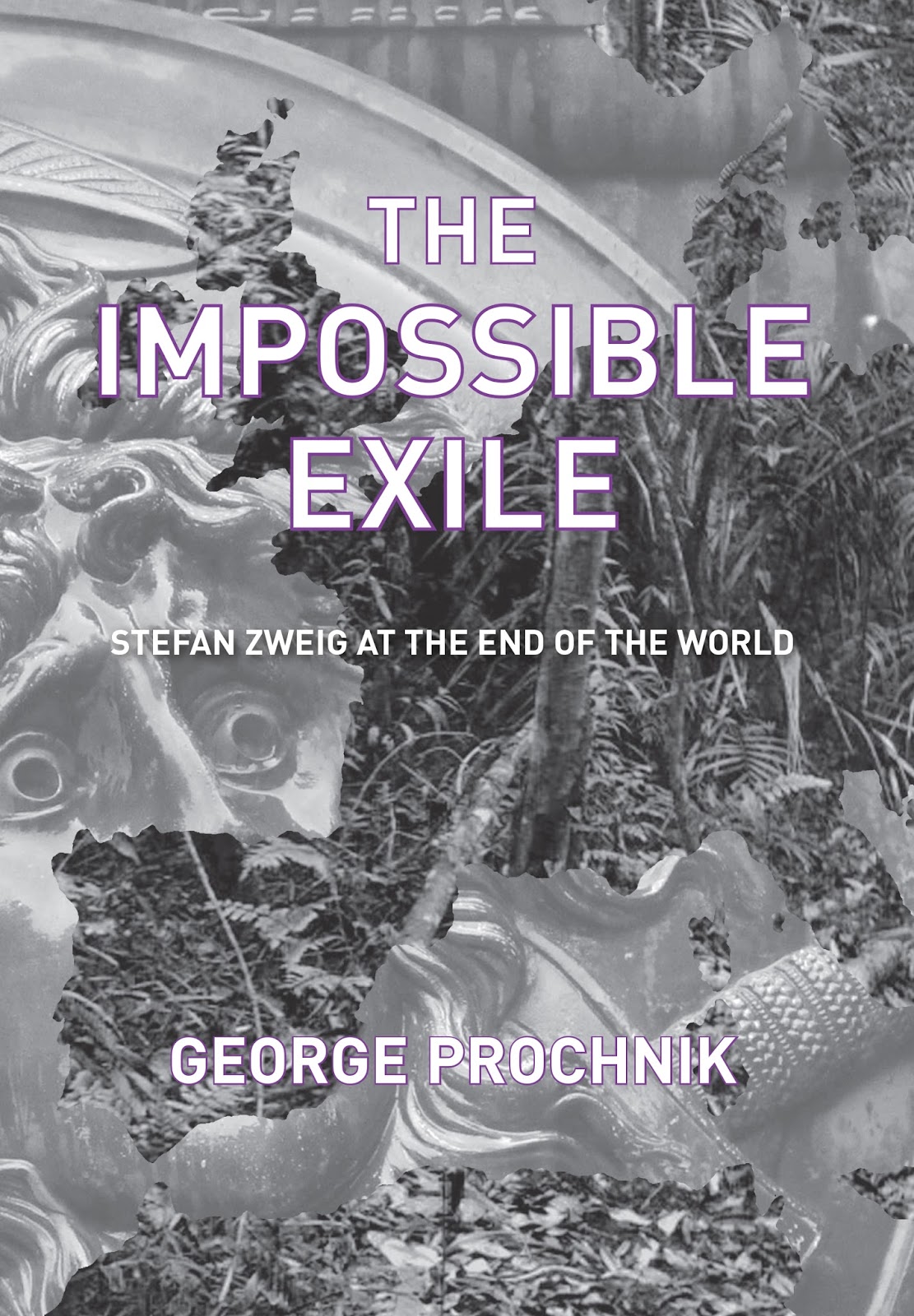 هذا هو موضوع كتاب "المنفى المستحيل" لجورج
بروشنيك، الذي يمثل دراسة آسرة، استثنائية الدقة، مؤلمة، صادقة. يسعى بروشنيك ـ
منطلقا من أرضية استقصائية لا تعرف الهوادة ـ إلى إيضاح الدوافع المحتملة لانتحار
كاتب لا يزال يحظى بانتشار نادر المثال، كان قد أكمل للتو عملين أساسيين: سيرته
"عالم الأمس" و"البرازيل: أرض المستقبل". وكان كذلك قد انتهى
من روايته الأكثر إدهاشا "قصة الشطرنج" التي عالج فيها أخيرا أهوال عمره
وعصره، ليثبت على أقل تقدير أن النوائب لم تنل من حيويته الإبداعية. كما كان قد
تزوج حديثا من امرأة لطيفة، تصغره بنحو ثلاثين عاما. واختار بمحض إرادته أن يرحل
عن الولايات المتحدة ليلجأ إلى البرازيل، البلد المضياف الذي أوقد جذوة خياله.
هذا هو موضوع كتاب "المنفى المستحيل" لجورج
بروشنيك، الذي يمثل دراسة آسرة، استثنائية الدقة، مؤلمة، صادقة. يسعى بروشنيك ـ
منطلقا من أرضية استقصائية لا تعرف الهوادة ـ إلى إيضاح الدوافع المحتملة لانتحار
كاتب لا يزال يحظى بانتشار نادر المثال، كان قد أكمل للتو عملين أساسيين: سيرته
"عالم الأمس" و"البرازيل: أرض المستقبل". وكان كذلك قد انتهى
من روايته الأكثر إدهاشا "قصة الشطرنج" التي عالج فيها أخيرا أهوال عمره
وعصره، ليثبت على أقل تقدير أن النوائب لم تنل من حيويته الإبداعية. كما كان قد
تزوج حديثا من امرأة لطيفة، تصغره بنحو ثلاثين عاما. واختار بمحض إرادته أن يرحل
عن الولايات المتحدة ليلجأ إلى البرازيل، البلد المضياف الذي أوقد جذوة خياله.
ما الذي جعل المنفى عصيا على احتمال شتيفان تسفايج في
حين أن فنانين غيره استلهموا من المنفى طاقة كبيرة وإلهاما؟ يلاحظ بروشنيك أن كلود
ليفي شتراوس: "وهو يسير في شوارع نيويورك للمرة الأولى سنة 1941، قد وصف
المدينة بالمكان الذي يبدو أي شيء فيه ممكنا ... وكتب أن سر فتنة المدينة هو
أنها تحمل في وقت واحد روائح أوربا الوسطى
الراكدة ـ وأوربا الوسطى هي مقر عالم أفل ـ مع حيوية أمريكية جديدة".
لم يمر تسفايج قط بلحظات رعب أو لحظات اتخاذ قرار
بالحياة أو الموت في غضون ساعات قلائل، ولا هو اضطر إلى تلقي ضربة قاصمة أو مواجهة
تحد جسيم يتمثل في إعادة بناء حياته المهنية. كان يبدو جيدا أنه يبتعد على خير قبل
أن تضربه الأمواج، بعدما يتاح له من الوقت ما يلزم لحزم حقائبه، ويتصرف في
ممتلكاته، وأهم من ذلك كله، أن ينتقي وجهته. فقد ترك النمسا وبيته الجميل في
سالزبرج سنة 1933. فبناء على زعم زائف بوجود مخبأ سري لأسلحة غير شرعية، أجرت الشرطة تفتيشا ساقه إلى الرحيل إلى
بريطانيا العظمى، تاركا زوجته "فريدريك" وابنتيها من زيجة أخرى. وخلافا
لزملائه الألمان ـ بمن فيهم "توماس مان" الذي رحل عن ألمانيا إثر صعود
هتلر إلى السلطة في يناير 1933 بلا أمل في الرجوع إلى وطنه ما لم يتغير النظام ـ
استطاع تسفايج أن يتنقل بحرية بين لندن وفيينا وسالزبرج لمدة خمس سنوات أخرى. كما
أتاح له جواز سفره النمساوي ـ الصالح حتى انتهاء احتلال ألمانيا للنمسا في مارس
1938 ـ أن يسافر إلى الولايات المتحدة
وأمريكا الجنوبية.
لكن صعود هتلر إلى السلطة كانت له عواقبه الفورية
الخطيرة على تسفايج، وأهمها فقدانه ناشره الألماني "إنسيل فيرلاج". ومع
ذلك بقيت كتب تسفايج متاحة في ألمانيا في مستهل الحقبة النازية، وإن منع عرضها أو
الإشارة إليها في الصحافة، ولكن مبيعاتها بقيت كما هي لم تكد تتغير في عامي 1933
و1934. والأكثر إدهاشا أن "ريتشارد شتراوس" الذي طلب من تسافيج كتابة
افتتاحية نصه الأوبرالي "المرأة الصامتة" قد حارب ضد رفع اسمه عن هذا
العمل، في وقت منعت فيه أية إشارة إلى الفنانين اليهود. كان افتتاح الأوبرا في
يونيو 1935، ولم تعرض بعد الافتتاح إلا ليليتين، لكن شتراوس كان مصرا ومتلهفا على
العمل مع تسفايج، فاقترح أن يبقى التعاون بينهما سرا إلى أن تتحسن الأحوال، ولكن
إحساس تسفايج بالتضامن مع الفنانين اليهود منعه من قبول ذلك العرض.
تلك السنوات الأولى من المنفى المريح لم تشهد أي دراما ـ
فقد كان تسفايج بارعا في تحاشي الدراما في حياته الشخصية ـ ولكنها شهدت عددا من
التغييرات الزواجية. كان شتيفان وزوجته في غاية التوافق، وطلب منها أن تستأجر لها
سكرتيرة حينما انتقل إلى لندن. فاختارت له اللاجئة الألمانية "لوتي
ألتمان" وهي شابة جادة رقيقة وكتومة فكانت مناسبة لتسفايج تماما. سافرت لوتي
معه كثيرا، وذهبت معه لمقابلة فريدريك في نيس قبل أن تقله السفينة إلى نيويورك.
كانت الإقامة في نيس تمضي في سلاسة، على الأقل إلى أن
طلب تسفايج من فريدريك المرور على القنصلية البريطانية لتسوية مشكلة ما. فلما وصلت
إلى القنصلية اكتشفت أنها نسيت ورقة مهمة فرجعت إلى الفندق لتحضرها. ودخلت الغرفة فوجدت
تسفايج ولوتي غارقين في النوم. استيقظا في فزع على دخولها، لكن فريدريك حافظت على
ثباتها، ووجدت الورقة، ورجعت إلى القنصلية، ولما رجعت لم تطلب طرد لوتي، بل إبعادها
فورا لبعض الوقت. ولم تمض أيام قليلة ختى كان تسفايج على السفينة. ورافقته فريدريك
إلى قمرته، وهنالك كان بانتظاره خطاب، عرف الاثنان فيه خط يد لوتي، وفاجأ تسفايج
زوجته بأن وضع الخطاب بين يديها دون أن يفتحه. والواقعة كلها تبدو لي بالغة
الدلالة على موهبته في التملص ومقته للصراع.
وصل تسفايج إلى نيويورك في يناير 1935، وهو في الرابعة
والخمسين وفي ذروة حياته المهنية. لم يكن روائيا في قامة "توماس مان"،
وكان يعرف ذلك. كان يكفيه فخرا أن النازيين أحرقوا كتبه مثلما أحرقوا كتب فرويد
وأينشتين والأخوين مان. لكن مبيعاته كانت تفوق من عداه. لقد كتب تسفايج إلى شتراوس
يقول إن "الإيجاز والتخفيف يبدوان لي نعمة في الفن"، فلا عجب أن يكون قد
آثر النوفيلا، وهي القالب الكتابي السريع المركز الذي يهب نفسه ببراعة للمواضيع
السريعة المبهرة، والذي حقق له وفرة من القراء المنهكين من "مباني القرن التاسع
عشر متعددة الطوابق". وكانت السير الذاتية التي يكتبها ويجعل فيها من نكهة
التاريخ الروائي أكثر مما فيها من وقع البحث المرهق ـ تحقق مبيعات جيدة للأسباب
نفسها. وكان قد نشر حديثا سيرة لـ إيراسموس اعتبرها بورتيها ذاتيا مقنَّعا، فقد
كان إيراسموس الإنساني يمثِّل قيمه بينما يمثِّل غريمه مارتن لوثر جانب الفاعل
فيه.
وحقق الكتاب نجاحا فوريا، حتى في ألمانيا. وبات تسافيج
مثار فضول الصحفيين، بشهرته، ومنفاه الاختياري، وصداقته لـ جوزيف روث وغيره من
الفنانين الذين أتت عليهم التطورات السياسية، وشبكة علاقاته باللاجئين في سويسرا
وبريطانيا العظمى وفرنسا، فبات الجميع راغبين في الاستماع إلى إدانته للنظام
النازي. وأقيم مؤتمر صحفي في مقر الناشر "فايكنج"، وفي مواجهة أسئلة
محددة من الصحفيين عن رأيه في هتلر، وعما يجري في ألمانيا، وعن الحالة الذهنية بين
الشعب الألماني وبين اللاجئين، راح تسفايج يراوغ ويتملص ويواجه الصحافة بـ "ثباته
المعهود النمطي" منهيا كلامه بقوله "إنني لن أتكلم مطلقا ضد ألمانيا، لن
أتكلم مطلقا ضد بلدي".
ولأن بروشنيك يعلم أن مهمة كاتب السيرة الذاتية ليست أن
يحاكم بل أن يحاول الفهم، فهو لا يلجأ إلى النهج التبسيطي فيدين موقف تسفايج
السلبي، بل يؤثر أن يراه بوصفه تجليا لأمل تسفايج في أن يسترد الشعب الألماني
رشده، ولعل ذلك بتأثير من استمرار تحقيق كتبه مبيعات عالية في ألمانيا. وهكذا
"فقد كان تسفايج يؤمن أن أفضل رد فعل على انتخاب هتلر ليس شيطنة مؤيديه، بل
تعريفهم بثراء الإرث الثقافي الألماني الذي تعرضه السياسات النازية للخطر".
ورأى تسفايج في إصدار مجلة أدبية شهرية تركِّز على المقالات المكتوبة بمختلف
اللغات وفقا لمعايير أخلاقية وأدبية رفيعة إمكانية لتعزيز الأخوة الأوربية
الأرستقراطية القادرة في نهاية المطاف على مواجهة الدعاية الدوجمائية التي تمارسها
القوى الرامية إلى الدمار المعنوي لأوربا.
لم يثمر المشروع عن شيء فعاد تسفايج المحبط إلى بريطانيا
العظمى وقد اقتنع أنه فقد كل تأثير له. وبات على يقين من استحالة إلحاق الهزيمة
بالنازيين بطريقتهم، فآثر الظن بأن الناس سوف ترى في صمته إدانة. وكان ذلك الموقف
أدق وأحرص من أن يفهمه اللاجئون السياسيون والرأي العام الأمريكي.
 |
| توماس مان |
وازداد ثقل صمته عن معارضة هتلر علنيا حينما ازداد نشاط "توماس
مان" السياسي أكثر وأكثر. ولما سحبت جامعة بون درجة مان الفخرية سنة 1936 كتب
هجوما مسهبا أكد فيه على "اشمئزازه البالغ مما يحدث في الوطن من أفعال
حقيرة". وراج في ألمانيا منشور من عشرين ألف نسخة محتويا هذا الهجوم، ثم ترجم
بعدها ووزع في الولايات المتحدة والعالم. وبذلك أصبح مان المتحدث الذي لا منافس له
باسم جميع فناني المنفى بحسب اعتراف توسكانيني الذي أثنى على النص "العظيم
المؤثر الأصيل الإنساني".
ومع ذلك بقي تسفايج صامتا. "كم يرغب المرء في
الانزواء في جحر فأر... كم أنا رجل لا يقدّر شيئا مثلما يقدِّر السلام
والهدوء". واستفاد من السنتين التاليتين ـ فقد بقيت النمسا مستقلة حتى 1938 ـ
فباع بيته في سالزبرج، وباع أيضا مجموعة مخطوطاته الاستثنائية، فلم يبق إلا على
النوادر منها ومكتب بيتهوفن. وأنهى زواجه مع احتفاظه بالصداقة بينه وبين فريدريك.
وبدا أنه يؤمِّن نفسه ليتعامل بهدوء مع الوبال الكبير:
"لقد تعلم جيلنا فنا عظيما، هو فن العيش بلا أمان.
نحن مجهَّزون لأي شيء ... وثمة متعة غامضة في حفاظ المرء على استقلاله العقلي
والروحي لا سيما حين يشيع التخبط ويسيطر الجنون".
وكان يخدع نفسه.
تغير كل شيء في سبتمبر من عام 1939 حينما أعلنت بريطانيا
العظمى الحرب على ألمانيا في أعقاب غزو بولندا. وبين عشية وضحاها بات تسفايج غريبا
معاديا في نظر بريطانيا العظمى، فكانت تلك من الناحية السيكولوجية صدمة وأي صدمة، فكتب
إلى ناشره يقول "أعتقد أنه ينبغي تعريف وزارة الإعلام الجديدة بالقليل على
أقل تقدير عن الأدب الألماني فتعرف أنني لست ’الغريب المعادي’ بل لعلي الرجل الذي
يمكن أن يكون (هو وتوماس مان) أنفع من سواه".
وبطبيعة الحال لم تكن بريطانيا على وشك اتخاذ خطوة حمقاء
كأن تضع كاتبا شهيرا في معسكر اعتقال، ولكن تسفايج اضطر إلى المضي في عملية مرهقة
لاستخراج أوراق هوية، وفي أثناء انتظارها، منع من السفر لأكثر من خمسة أميال بعيدا
عن مقر إقامته إلا بتصريح خاص كان بدوره يستهلك من وقته ساعات في مناقشات مطولة مع
موظفين لم يسمعوا باسمه من قبل. واستعر غضبه بسبب حرمانه من لغته. فلم يعد الآن
مستحيلا عليه أن ينشر أي شيء في ألمانيا وحسب، بل لقد وجهت النصيحة للاجئين
الألمان بألا يتكلموا الألمانية علنا. فكتب في يومياته يقول "إن لغتنا ...
أبعدت عنا، ونحن نعيش في بلد ... لا حظ لنا فيه إلا التسامح. وإنني حبيس لغة لا
أستطيع استخدامها".
وعلى الرغم من سخطه، فعل كل ما يلزمه ليكون من الرعايا
الطبيعيين فأكمل الإجراءات في مارس 1940، لنفسه ولـ لوتي التي كان قد تزوجها قبل
أشهر قليلة. وفي الوقت نفسه اشترى عددا من سندات الادخار الأمريكية وطلب من ناشره
الأمريكي "بن هويبش" أن يحتفظ له بها. وتلاحقت الأحدث فاهتز بشدة لسقوط
فرنسا. كان خطر غزو إنجلترا يبث الرعب في أوصاله. وأخيرا، والتزاما منه بعادته في
اللجوء إلى النفي قبل الأوان، رحل إلى نيويورك مع لوتي في يوليو من عام 1940.
وكان رجل غير الرجل هو الذي وطأت قدماه أمريكا. محبط،
ممرور، ضائق برفاهية نيويورك وبهائها وإشعاعها، مشمئز من شيخوخته إلى حد تجربته
حقن الهرمونات فلا تجعل منه إلا مرهقا حزينا مثلما كان قبلها. كان في غاية البؤس.
ولم تكن في تلك المرحلة من حياته من نقطة ساطعة إلا وصول فريدرك التي ادخر لها
واحدة من تأشيرات الدخول الخاصة التي خُصِّصت للمفكرين المهددين بالخطر.
من الطرق الممكنة لفهم تسفايج هي أن ننظر إليه في مقابل "توماس
مان"، الذي وصل إلى الولايات المتحدة في الوقت نفسه تقريبا، فأعلن بحدة أنه
الممثل لأفضل ما في ألمانيا: "حيثما أكون فثمة ألمانيا... بداخلي ثقافة
ألمانيا. وأنا على اتصال بالعالم ولا أعتبر نفسي مهزوما". أما تسفايج فكانت
تنقصه هذه الثقة بالنفس، فقال ناعيا نفسه إن "الهجرة تعني تحولا في مركز
الثقل لدى المرء". لقد كان الفارق الأساسي بين الرجلين أن مان كان ينتمي إلى
البرجوازية الألمانية العليا، ويضرب بجذور تمتد إلى عمق أجيال كثيرة في الماضي
الألماني، أما تسفايج فيهودي رفض الصهيونية وكان يقدِّر أكثر ما يقدِّر "قيمة
الحرية المطلقة في الاختيار بين الأمم، فيشعر المرء أنه أينما حل ضيف".
يدرك بروشنيك جيدا التحول المؤلم في صورة المنفي عن نفسه
بسبب منفاه، يبيِّن بوضوح كيف أن الكاتب الأنيق ابن فيينا ـ الذي يرى نفسه حرا في
أن يذهب حيث يشاء، والذي لا يبدو يهوديا لدرجة أن أمه شكت في تحوله عن الدين،
والذي تزوج من كاثوليكية[ii]
ـ يوضح بروشنيك كيف أن هذا الكاتب شعر باليأس حينما رأى نفسه ينحدر فجأة إلى مرتبة
يهود الشتات".
كانت معاناة تسفايج كبيرة لأنه كان يدرك، مهما تكن
الحياة التي يعيشها ثرية ورغدة وهينة كيهودي مندمج في مجتمعه، مدى اضطراب الحياة
التي يعيشها أبناء دينه. وهنا يورد بروشنيك قصة دالة:
حدث ذات يوم في عشرينيات القرن العشرين أن كان تسفايج
يسافر في ألمانيا برفقة [الكاتب المسرحي] أوتو زاريك، وتوقف الرجلان لزيارة معرض
لتحف الأثاث في ميونخ. وثمة توقف تسفايج قبل أن يصل إلى خزائن خشبية ضخمة ترجع إلى
القرون الوسطى.
وسأل فجأة "هل تقدر أن تخبرني أي هذه الخزائن كان
يخص يهودا؟" فنظر زاريك في تشكك وقد بدت له الخزائن جميعا متساوية في جودتها
العالية وتخلو من أي علامات ظاهرة تدل على ملكيتها.
ابتسم تسفايج. "هل ترى هاتين؟ هاتان محمولتان على
عجل. هاتان كانتا ليهود. ففي تلك الأيام ـ ودائما في واقع الأمر ـ لم يكن اليهود
يعرفون قط متى ستنطلق الصافرة، ويعلو صليل المذبحة. كان عليهم أن يكونوا متأهبين
طول الوقت للفرار في أية لحظة".
ويصل إلينا انطباع بأنه وقع بغتة في قبضة خوف موروث وأن
ذلك الكابوس كان متغلغلا في لاوعيه ثم تحول الكابوس بغتة إلى واقع.
ووقع تغير آخر في موقفه ممن كانوا يقصدونه طلبا
للمساعدة. فقد كان في السابق سخيا، ثم بدأ عدد قاصديه في التزايد فأدرك أنه غير
قادر على الاستمرار: "[أنا] ضحية سيل عرم من اللاجئين ... ثم كيف يمكن مساعدة
هؤلاء الكتاب وما كان لهم حتى في بلدهم شأن ولا ذكر؟"
ظل الشلل الذي أصابه به رفضه اتخاذ موقف سياسي واضح
يمنعه من اتباع مثال مان، كما ظل محاصرا باللاجئين طالبي العون، ومنظمات الإغاثة
طالبة الدعم. ولما طلب منه أن يلقي كلمة مدتها عشر دقائق في فعالية تستهدف جمع
التبرعات لـ "لجنة الإنقاذ والطوارئ"، قضى ساعات في محاولة الخروج بخطبة
لا تسيء إلى أحد: "أريد أن أقول كلمة يفهم منها أنني أشجّع أمريكا على دخول الحرب،
لا كلمة تعلن النصر، أو تبرر الحرب أو تمجدها، وينبغي أن يكون للكلمة صدى
متفائل".
كان الحل الوحيد الذي توصل إليه هو أن ينغمس في عمله.
فترك نيويورك ولاذ بـ أوسينينج حيث أمكنه الانتهاء من سيرته الذاتية، وكان قد
انتهى من كتابه عن البرازيل. كانت تلك البلدة اختيارا غريبا، فهي محرومة من كل
فتنة أو جمال، تقع في ظل سجن "سينج سينج"، ولكن ظل اختيارها مبررا بوجود
فردريك، التي كانت عونا له ولا شك على التحقق من تفصيلات معينة في نصه. أخذ يعمل
بلا هوادة، وفي نهاية صيف 1941، وفي حالة من الإعياء، والتوق إلى حياة توفر له
درجة ما من الاستقرار، قرر الرجوع إلى البرازيل التي وفرت له تصريحا دائما
للإقامة.
وأخفق هذا القرار في منحه الهدوء الذي كان يتوقعه. وبرغم أن كتابه عن
البرازيل حقق مبيعات معقولة، إلا أنه لم يلق قبولا بين النقاد البرازيليين الذين
ضايقتهم نظرة تسفايج الغرائبية التصويرية. واستمرارا في بحثه عن الوداعة، ترك مدينة
ريو إلى بلدة بتروبوليس الصغيرة، وكتب إلى فردريك يقول إن "المرء يعيش هنا
أقرب إلى نفسه وفي قلب الطبيعة، فلا يسمع شيئا عن السياسة... ولا يمكن أن نضيع حياتنا
كلها على غباوات السياسة التي لا تعطينا شيئا بل تأخذ منا وتأخذ". ومرة أخرى،
كان يخدع نفسه.
في السابع من ديسمبر، هاجم اليابانيون الأسطول الأمريكي
في ميناء بيرل. وفي اليوم التالي أعلنت الولايات المتحدة الحرب. ومرة أخرى استولى
على تسفايج ذعر لا مبرر له. كان يخاف الغزو الألماني لأمريكا الجنوبية. وبدا أن كل
مخرج ممكن مسدود تماما. شعر باليأس لوجوده "على بعد أميال وأميال من كل حياتي
السابقة وكتبي وحفلاتي وأصحابي
وحواراتي". ولكن كان ثمة شيء ثابت في حياة تسفايج، هو اندفاعه إلى الكتابة.
فقد شرع يعمل على النوفيلا الأخيرة "قصة الشطرنج" وللمرة الأولى أدخل
النازيين في حبكته. في قصته يتعرض محام نمساوي للاعتقال في فيينا. ويخضعه الجستابو
لشكل من العذاب الذهني لا رحمة فيه. يحبس الرجل في غرفة في فندق، معزولا عن أي
اتصال بشري، محروما من الكتب، والقلم، والورق، والسجائر، محكوما عليه بقضاء أسابيع
بين أربعة جدران جرداء: "لم يكن هناك ما يفعله، أو يسمعه، أو يراه، في كل
موضع حوله اللاشيء، العدم التام، حيث لا أبعاد، ولا زمان". انتهى من الكتابة
في الثاني والعشرين من فبراير، وفي اليوم التالي، شرب هو ولوتي جرعة قاتلة من
فيرونال.
 |
| بروشنيك |
الصورة التي التقطتها الشرطة تظهره مستلقيا على ظهره،
ويداه متشابكتان، وهي مستلقية بجواره، ورأسها على كتفه، وإحدى يديها على يده.
ويخلص بروشنيك من الصورة بقوله: "هو يبدو ميتا، هي تبدو عاشقة".
"مات إلى الأبد؟" هكذا يتساءل راوي بروست
عندما يموت الكاتب بيرجوتي. بالنسبة لبروست لا يمكن أن يموت فنان إن عاشت أعماله
من بعده. وفي عام 1942، لا شك أن تسيفايج بدا ميتا. فلم يكن أحد مستمرا في قراءة
كتبه. ولكنه كان في مرحلة المطهر الوسطى وحسب. فبعد أن انتهت الحرب سرعان ما أعيدت
طباعة كتبه في النمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ـ وكان أكبر الإقبال على
"عالم الأمس" ـ ثم في بريطانيا العظمى بعد ذلك والولايات المتحدة. وفي
وقت قريب، وبفضل نيويورك رفيو أوف بوكس ومطبعة بوشكن، أعيد نشر جزء كبير من
مؤلفاته بترجمات جديدة، فثمة صحوة قائمة في الاهتمام بتسيفايج.
نشرت هذه الترجمة في جريدة عمان الأسبوع الماضي وهي مأخوذة عن الترجمة الإنجليزية (من الفرنسية) التي قام بها أنطوني شوجار. وللمقال بقية تستعرض فيلم "فندق بودابست العظيم" يمكن لمن يشاء أن يطالعها في ترجمتها الإنجليزية على نيويورك رفيو أوف بوكس

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق